
ساندت بوليساريو ولم تشرك المملكة في مؤتمر برلين حول ليبيا وانزعجت من دورها الإفريقي...
قررت المملكة المغربية تجميد علاقاتها مع السفارة الألمانية بالرباط مع وقف جميع آليات التواصل معها والمنظمات الألمانية التي تنشط بالمغرب، بناء على رسالة وزير الخارجية والتعاون الموجهة إلى رئيس الحكومة.
قرار تجميد العلاقات لم يوضح الأسباب الكامنة وراء ذلك، لكن تتبعنا لعدد من مواقف السلطات الألمانية تجاه المغرب خلال السنتين الأخيرتين يؤدي بنا إلى معرفة حقيقة الأسباب، التي كانت وراء الموقف المغربي.
تاريخ العلاقات
بداية، من المفيد التذكير بعمق العلاقات التاريخية بين ألمانيا والمغرب، إذ يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين إلى 1506، حيث أنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية، وقد تم التوقيع على أول اتفاقية بين المغرب ومدينة هامبورغ لتنظيم سير السفن في الموانئ المغربية في 1802.
وفي أواخر القرن التاسع عشر بادر المستشار الألماني بسمارك باتخاذ قرار بفتح القنصلية الألمانية بطنجة في عهد السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن، وتعززت بعد ذلك العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة في عهد المرحوم الملك الحسن الثاني. وقد ازدهرت العلاقات الألمانية – المغربية أكثر في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث توسع نشاط العديد من المؤسسات الألمانية التي تنشط في مجال التنمية السياسية في المغرب، أهمها “مؤسسة كونرادادناور”، و”مؤسسة “فريدريش ايبرت”، و”مؤسسة فرديدريشناومان”، بالإضافة إلى مؤسسات ثقافية أخرى، فضلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركات ألمانية تستثمر في المغرب وتحظى بجميع الضمانات والامتيازات القانونية في إطار تعاون اقتصادي مثمر حقق نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، استفادت منه بالدرجة الأولى هذه المقاولات.
ألمانيا تتحرش بالمغرب
كيف يعقــل أن تتحـرش ألمانيا بالمغرب، الذي تربطه معها علاقات تاريخية، تعززت على جميع الأصعدة، كان المغرب دائما خلالها حريصا على تمتين هذه العلاقات والسعي إلى تطويرها إلى ما هو أفضل، بل كان مساندا للحكومة الألمانية ومتعاونا معها في ملف محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
فمباشرة بعد قرار اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال دجنبر 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، طالب السفير الألماني في الأمم المتحدة بجلسة مغلقة لبحث هذا النزاع، وكان ذلك يوم 22 دجنبر، خاصة أنه أبدى تعاطفا مع جبهة بوليساريو بدعم جزائري، مما اعتبره البعض تشكيكا علنيا لألمانيا في شرعية القرار الأمريكي، وتحيزا واضحا لجهة معادية للمغرب.
لم تقف ألمانيا عند هذا الحد، بل سعت من خلال دورها المؤثر في الاتحاد الأوربي إلى معارضة مساع فرنسية داخل الاتحاد لبلورة موقف مساند للسيادة المغربية على الصحراء لدعم الموقف الأمريكي، خاصة أن كثيرا من الدول الأوربية نوهت بالموقف الأمريكي الرصين، وكانت على وشك اتخاذ موقف موحد على نطاق واسع، لولا الضغط الألماني. ثم لم تكتف ألمانيا بمناوراتها داخل أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، بل وظفت بعض مؤسساتها التي تنشط في المغرب للقيام بأنشطة استخباراتية تضر بالمصالح العليا للمغرب.
تحرشات ألمانيا، في الحقيقة، لم تبدأ منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق عن قراره بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، بل بدأت منذ يناير 2020، عندما سعت ألمانيا إلى إقصاء المغرب من خلال عدم دعوته لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، علما أن المغرب كان له إسهام كبير في حل النزاع الليبي وتحقيق السلام بالمنطقة، ويشهد على ذلك اتفاق الصخيرات التاريخي الذي وافقت عليه الأطراف الليبية في دجنبر من 2015، والذي كان سيتحقق لولا إجهاضه مع الأسف من قبل دول عربية وأوربية. مع الإشارة في هذا الصدد، أن ألمانيا أصبحت منزعجة من الدور المغربي الرائد في إفريقيا، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، وأيضا من استثماراته في عدد من دول غرب وشرق إفريقيا، ناهيك عن موقعه الجيوإستراتيجي بين أوربا والقارة الإفريقية، مما جعل ألمانيا ترى في المغرب منافسا لها على مستوى الاستثمارات في هذه القارة، وما تدخلها في النزاع الليبي إلا وسيلة لإقامة استثمارات بليبيا، وبالتالي البحث لها عن منفذ لاكتساح أسواق إفريقية، انطلاقا من تشاد والنيجر، فضلا عن ذلك، لاحظنا أن السعار الألماني تجاه المغرب ازداد خلال الأيام الأخيرة، عندما احتفت جبهة بوليساريو برفع علمها أمام البرلمان الألماني الجهوي في “بريمن” بمناسبة الذكرى الـ 45 لإعلان “الجمهورية الوهمية”، بإيعاز من السلطات الألمانية، وهو ما زاد الطين بلة.
وهذا التصرف يعبر بشكل واضح، وبما لا يدع أي مجال للشك، على أن ألمانيا صارت تشن حربا سياسية على المصالح العليـا للمغرب، وعلـى رأسها وحدته الترابية، في خرق سافر للعلاقات والمصالح التي تجمع البلدين.
(*) أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال
بقلم: خالد الشرقاوي السموني(*)
(1)%20(1).jpg)
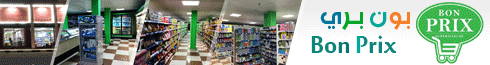

.gif)



.gif)





.jpg)
.png)


